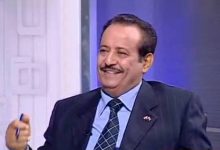العيد الأخير للجدة

يمنات
لطف الصراري
من أفرغ قلبي من حبّه ملأه بالضغينة تجاهه”… قالت جارتنا العجوز وهي تحصي أحفادها وتوزّع حبّها وضغائنها على آبائهم وأمّهاتهم.
مريم السنانية، هذا هو اسم شهرتها منذ جاءت إلى قريتنا مزفوفة على هودج وخمسة جمال في موكب عرس غير مسبوق. جدّتي تتذكّر ذلك اليوم، لأن موكبها حين زُفّت لجدّي، كان ينقصه جملان عن موكب “السنانية”. ويقال إنها بقدر ما كانت كريمة، لدرجة استقبال ضيوف زوجها في غيابه، فقد كانت تجاهر بتحقير كلّ شخص ترى أنه يستحقّ ذلك.
لم تكن تعرف ما هو الشعر، لكن صوتها العذب طالما شدا بأهازيج الحطابات وجالبات الماء قبل شروق الشمس، وطالما درّبت الفتيات على أهازيج المساء. وبعد أن صار لديها جوقة لا تقلّ عن عشرة فتيات، ظلّت مريم السنانية تقودهن بصوت شجي استعصى على الشيخوخة حتّى بلغت الثمانين. خلال هذا العمر، لم تمل من ترتيب الفتيات بعد كلّ صلاة مغرب، دائرتان في كلّ منهما خمس فتيات يدرن متشابكات الأيدي، بتناغم أزلي مع إيقاع اللحن الذي لم يمت في الأفواه منذ مئات السنين، يردّدن الأهزوجة الأثيرة إلى روح قائدة الجوقة، الأهزوجة التي تحتفي بذكر مسقط رأسها: الجند، حيث أناخت راحلة مبعوث النبي، وحيث بنى معاذ بن جبل أوّل مسجد في بلاد سبأ وحِميَر.
“يا طولقة في الجَنَد ردي عُزيرك بَرود
تحتك عيال الهوى سبعة سهارى رقود
منكّسين السلاح مندّشين الجعود
وبينهم فاطمة تقرا الثلاثة العهود”
على هذه الأهزوجة درّبت جوقتها، وقيّمت أداء “عضواتها” بناء على إجادتها بدون أن تسمح بأي قدر من النشاز. وخلال التمارين أو الأداء النهائي، برعت مريم في التعبير عن حسّها الفنّي بناء على شعورها بالنفور والرضا. ذات مرّة، قالت لفتاة كانت كثيرة التنشيز: “صوتك يخرج من المهجل مثل أسنان أمك الجهصاء”. ومنذ ذلك الحين، لم تجرؤ فتاة على الإنضمام للجوقة ما لم تكن أسنان أمّها منتظمة، أو تثق بأن صوتها جيّد للغناء. في الحقيقة، كانت لمريم تلك الفراسة الفطرية للتمييز بين الجيّد والرديء، وبالمثل، التعرّف على الحبّ والكراهية من ملامح الوجوه، السلوك، وردّات الفعل إزاء كلماتها الحادّة.
لم تقتصر فراستها تلك على أداء جوقة “المهاجل”، إذ مع مرور الزمن، صار واضحاً للجميع أن النباهة والصراحة وحسن تقدير الأمور، ليست مجرّد صفات مكتسبة لديها بقدر ما هي طباع ولدت معها. وبهذه الطباع، عاشت حياتها، وتعاملت مع الصغير والكبير بما يستحقّ. بالنسبة لأحفادها مثلاً، تقول لأحدهم: “سير اشتري لي حبتين بندول من الدكان”، وعندما تلمح تلكّؤه، تضيف قبل أن يردّ عليها بالرفض: “وخذ لك عشرة ريال من الباقي”. موقف كهذا لا يمرّ مرور الكرام بالنسبة للجدّة التي عرفت كيف توظّف شيخوختها وأحفادها العصاة لتوبيخ أبنائها وزوجاتهم وبناتها وأزواجهن. “قدني دارية ان نفسك تفلت على البِيَس مثل امك”، أو “مثل أبيك.” تقول للحفيد المتلكّئ.
رغم ذلك، لم تكن تأتي على ذكر ابنها الذي أصرّ على الذهاب إلى جبهات الحرب وعاد إليها بعد ثلاثة أشهر في تابوت. كانت تنهال بالشتائم الفاحشة على زوجته لأنها لم تحاول منعه من الذهاب إلى حتفه، تاركاً وراءه ثمانية أطفال سيكون على الجدّة تربيتهم إلى نهاية حياتها التي لن تطول أكثر من سنة أخرى. بعد أسبوعين فقط من دفن ابنها “الشهيد”، وصل تابوت “شهيد” آخر من العائلة، لكنّه هذه المرّة زوج ابنتها، وهو قبل كلّ شيء ابن أخيها. بذلك ازداد عدد الأحفاد الذين عليها رعايتهم إلى ثلاثة عشر. كان هذا كافياً لتعيد توزيع شتائمها الفاحشة بالتساوي على ابنتها وزوجة ابنها المترمّلتين. ولكي تعيل اليتامى، فرضت على أبنائها وأصهارها مبلغاً شهرياً لا يقلّ عن خمسة آلاف ريال. وفي نهاية كل شهر، كانت تذهب إلى سوق المديرية، برفقة أشرف، الولد البكر لابنها الرابع، وهو الوحيد الذي يعرف ما تحتويه شوالات الخيش والنايلون الأبيض والصناديق الخشبية المتراكمة في مخزن الدار. كانت تثق به وتحبّ أمّه لدرجة تعيير نساء العائلة بأنهن لا يساوين شيئاً أمام “رقية”.
كانت للجدّة مريم تلك القدرة النادرة على التنقّل في غضون ثوانٍ قليلة، بين القسوة والحنان الغامر، وبين الشتائم الفاحشة وتبجيل الفضائل. تعرف أيضاً كيف تصف ضغائنها ومزايا قلبها الطيّب، دون الحاجة إلى لغة فخمة وأسنان ثابتة. “يلعن اماتكم اللي ما قدرينش يصبرين بعد ازواجهن حتّى سنة… مستعجلات على البودرة وفشخ الأرجل… الله يحفظك يا رقية… مره تسوى ألف”، تقول ذلك رغم أنها كانت أوّل المباركين لتزويج الأرملتين. وحين تشعر بإلحاح رغبتها في اللعن، لم تكن تتحفّظ أمام أحد، وطالما أمعنت في الشتم كلّما ضحك أفراد العائلة الكبيرة والجيران على ذلك الفحش وتلك العصبية الملازمة لصوتها وملامح وجهها.
أحياناً، خاصّة في عيد الأضحى، كان يأتي إليها كلّ أحفادها، فيصبح الدار ذو الطوابق الثلاثة أشبه بخلية نحل عمودية. وذات ظهيرة قائظة، تحديداً يوم الوقفة الكبيرة لعيد الأضحى الذي سبق موتها بشهر، أحصت 70 حفيداً وقالت إنهم مئة. كانت تذكّرهم بعددهم أثناء ما كان بعضهم يرشون الماء أمام الدار لتفادي إثارة الغبار أثناء لعبهم في اليوم التالي؛ يوم العيد. الآخرون كلّفتهم بري أشجار الرياحين في الباحة الداخلية، وجلب الماء من خزّان البئر أسفل القرية.
كنت أراقب تلك الحشود متفاوتة الأحجام من سقف بيتنا الذي لا يبعد عنهم بأكثر من ثلاثين متراً. كم تمنّيت أن تكون لي جدّة مثل مريم السنانية، وكنت أظنّ أنّها حتّى إذا استطاعت أن تغمرهم بعاطفتها المتأرجحة بين حنان الجدّة وتقريعها اللاذع، فلن تملك الحلوى لكلّ أولئك الأحفاد.
لكنّها في صبيحة يوم عيدها الأخير، جلست على حصيرتها الخضراء في ركن الفناء من الخارج. أمسكت بين ركبتيها “الَأجَب” الملطخ ببقع السمن البلدي والغبار والطحين، قُفّة كبيرة محبوكة من سعف النخيل الجاف، مليئة بأصناف الحلوى، تُدخل يديها المخطّطتين بالتجاعيد والأوردة الزرقاء، وترمي بحلوى العطوي الملوّنة و”المليم أبو عسل”، وتصرخ بالأحفاد المتحلّقين حول الثور الذي سيذبح بعد قليل: “اهربوا من الدم لا توسخوش بدلات العيد. ارجعوا ها واني فدا. الله يلعن اماتكم ارجعوا”. بين تلك اللعنات العيدية والحلوى، كان يطير حبّها الذي ادّخرته لأجل هذه الأسراب الحاشدة من الأحفاد. وعندما ماتت، ارتسمت على وجهها ابتسامة خفيفة وتلاشت منه بعض التجاعيد. كانت قد استفرغت قلبها تماماً من الضغينة والحبّ، ومن أنكاد خمس وثمانين سنة.
المصدر: العربي