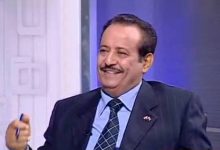التوجيه بإخلاء سبيلي

يمنات
أحمد سيف حاشد
رغم الحجز كنت أحاول أن أكتشف محيطي.. أرمق الذين يتجولون في الساحة القريبة بلباس مدني أو عسكري.. أحاول أن أمعن النظر في أشكالهم.. أتفرس في وجوههم إن أمكن، وهم يتجولون في الساحة، أو يمرقون منها ذهابا وإيابا، فيما كان بعضهم يطل من باب الغرفة يتفرّس فيني، وكأنني مخلوق عجيب جاء من الفضاء، أو حيوان بري عدواني، أو غير معروف، في سياجه الحديدي المخصص بحديقة الحيوان..
الضابط ذو الملامح الحادة الذي استقبل قدومي بنظرات حازمة ومتحفزة، كان يغيب أحيانا، ويعود للظهور أحيانا أخرى، ثم يرمقني شزرا ويذهب.. وأحيانا يجوس في الساحة، وهو منهمك يهاتف أغلب الظن العمليات، أو أحد رؤسائه الكبار.. لا أدري مضمون تلك المكالمات التي كان يجريها، إلا أنني كنت أخمّنها على الأرجح إنها تخصّني، أو تتحدث في شأني..
أما جندي الحراسة الصامت، فقد حاولت أن أفتح معه بابا للحديث والتعارف؛ فسألته عن المدة التي تعسكر فيها، والمحافظة التي ينتمي إليها، ولكنه تعمد أن يظهر أنه لم يسمع سؤالي الأول، وتجاهل عمدا سؤالي الثاني، فأرحته من ثالث ورابع؛ وفهمت إن الأوامر قد صدرت إليه ابتدأ أن لا يتحدث معي بقليل أو كثير..
ورغم هذا أحسست من نظراته القليلة التي كان يرمقني بها، أن ثمة تعاطفا ما في داخله.. شعور طيب تتسلل إلى نفسي كجدول أو ساقية.. نظراته القليلة نحوي بدت لي كمن يختلسها بغتة.. أحسست من نظراته إنها لا تخلوا من خجل وحيرة وتساؤل، وفي نفس الوقت يخامرها تعاطف مشوبا بقلة حيلة..
وفي المقابل أحسست من جهتي بتعاطف نحوه، لا يخلوا من تفهم وشفقة.. إنه مجرد عسكري ينفذ الأوامر فحسب.. يؤدي نوبة حراسة لا أكثر.. إنه عسكري مخنوق براتبه، وبآوامر رؤسائه الذي تقع عليه واجب طاعتها وتنفيذها، طالما كانت في حدود مهمته..
***
والشيء بالشيء يذكر لبيان وجه من المفارقة بين سلوك وآخر بمقام مشابه.. هذا الحارس المتعاطف والحائر هنا، كان على عكس الشاب “الأنصاري” الهمجي المتحفز، والاستعراضي المتعجرف الذي كان أمامي فوق الطقم يوم 25 مايو 2017.. كانت عيناه تقدح بسيل من الكراهية المقيتة، والعصبية المنتنة، ومثلها لؤم متسع، وجهل مطبق على آخره..
كان كمن يريد أن يغرس أصبعيه في عينيي.. يتجهم في وجهي كنار جهنم.. يتحفز إلى التهامي كضبع جائع.. يتهمني بالوهابية والدعشنة بجهل لا حدود له.. يتفرس شكلي كناهب أو قاطع طريق.. يفتشني ويسألني عن تلفوني ليغنمه، فيما كنت قد سلّمت تلفوني لابني فادي المحتجز في قسم شرطة جمال جميل مع مجموعة من المحتجين.. سلمته إليه حالما تم مناداتي للصعود إلى الطقم بمفردي.. هذا الكائن السادي الذي كان أمامي أحسست أنه متشوقا على نحو عاصف ليمارس ركلي ببيادته العسكرية، وهو ما حدث بالفعل بعد أقل من ساعة أو ثلثيها..
***
وعودة إلى الغرفة التي كنت محتجز فيها، وبعد قرابة الساعة تفاجأت بالضابط المتحفز قد خمد وهمد رغما عنه.. رأيته منكسرا وهو زاما شفتيه وقاطبا لحاجبيه، بوجه عابس مكسوا بخيبة أكبر من أن تدارى.. أمر الحارس بامتعاض أقوى منه بإخلاء سبيلي، دون أن يتحدث معي ببنت شفة.. لقد خاب مراده، وأحبط عمله، و”عاد بخفي حنين”..
خرجت بمرافقة أحدهم إلى البوابة الخارجية، ووجدت المعتصمين في الساحة ينتظروني وقد رفضوا مغادرة الساحة التي كانوا فيها.. انفرجت أساريرهم بمجرد أن شاهدوني مقبلا نحوهم.. استقبلوني بحرارة نادرة واشتياق جم، وكأنني عائدا من القمر ليعرفوا عني وعنه كل الأخبار التي أحملها معي إليهم..
جميعهم كانوا شغوفين أن يسمعوا منّي ما حدث!! فيما كنت مقلا بالكلام، وصدري يفيض بالقهر الذي حاولت بقلة حيله أن أداريه عن أعينهم المتفحصة.. لم استطع الضحك، وفشلت في تصنع الابتسامة، وهو ما فسره البعض أنني تعرضت لسوء أشد لا أريد البوح به.. ربما ظن البعض أنني تعرضت للضرب والإهانة في الداخل، ولا أريد أن أفصح عنهما أمامهم..
بعد سويعات قليلة كتبت رشيدة القيلي على الأنترنت شيئا عنّي وعن اللحظة، وعن عيوني الحزينة والمتألمة بوصف أشارت فيه بانفراد، إلى وجود دمعة في عيوني، وهذه الأخيرة لست لأنها لم ترقني، بل لأنها غير مطابقة للواقع، اتصلتُ برشيدة، أعتب عليها، وأطلب منها أن تحذف ما كتبته.. فاستجابت لطلبي، وحذفته، معلقة أنها بديت لها في تلك اللحظات وكأن دمعة القهر تجوس في عيوني، وربما عيوني كانت مرهقة، وما كتبته كان بدافع التعاطف معي.. وكنتُ قد قررتُ بدافع قهر قوي أن أثير الموضوع في البرلمان على نحو غير معتاد، وهو ما حدث بالفعل..
***
يتبع..
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520.